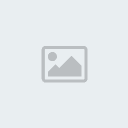حجم الصورة : 20 KB
للكاتب ------------- مصطفى سعيد --------------
عن الدار العربية للعلوم ـ ناشرون، في بيروت، صدر مؤخراً للكاتب الكردي ـ بالعربية، مصطفى سعيد، رواية (أكراد، أسياد، بلاجياد). تقع الرواية في مئتين وثماني صفحات. يذكر أن الكاتب، كان قد أصدر عمله الشعري الأول عن دار الكفاح في بيروت، 2006، وكان بعنوان "البداية والنهاية في الحب"، كما سيصدر له قريباً: رواية "ده ملياه".
ننشر هنا الفصل الأول من الرواية، والذي خصه الروائي، بموقع "حجلنامه"و"syriakurds".
دغدغ وجنتي انبثاقُ الشمس الخجولة، تخفي نفسها خلف الغيوم تارةً وتظهر في كبد السماء الشاحبة تارةً أخرى، كأن شيئاً لم يكن، ينكب شعاعها الخافت مثل آمالنا، من ستارة بيتنا القديمة، مزركشة بألوان غير متجانسة كأحلامي تلك الليلة، كابرت على نفسها، لتكسي النافذة ككسوة عروسٍ ثكلى بثياب سوداء بالية، قلبها حزين، لكن من يراها يحسب تطايرها مع هبات النسيم من هول فرحها...
فتحت عيني، وأنا أخدع نفسي، بأن النوم لازال يطرح جسدي، وسواس ثائر ينتابني من ملائكة الحنين أني بحاجة إلى نوم سرمدي لا أستيقظ منه إلا بين تراب قريتي، نبضات قلبي تلعنني، تدق في شغفٍ كقرع طبول قبائل سوبرتو، حزينةً لا تريد ترك جثتي التي رافقتها عدة من السنين، لتزيد من خفقانها وترسم ألوان لومها لعدم يقظتي وطرد الضيف الثقيل عني، بين حيرتي ولوعتي، قررت أن أكون رسول خير بينهم وأظل ممدداً في فراشي الملطخ بأحرفٍ متناثرة مبلولة بماء الأسى، علني أرضي في أسوأ احتمال حواسي..
أطلقت العنان لناظري، لتتأمل الغرفة الحزينة التي لم أعهد الاستيقاظ فيها، أصبحت ارتادها وأنام فيها قبل رحيلي، لأختصر رحلتي عند احتضاري، لأن الجثمان يوضع في أكبر غرف البيت عند النحيب عليه، أملاً أن أجد نفسي مقتاداً لقريتي، جثة هامدة، كهلاً، عاجزاً، شجرةً، صخرةً، لا فرق عندي، المهم أن أكون في مهدي ولحدي أن أدفن بين عظام أجدادي...
تسلل طيف جدي إلى ساحة نزال بين أفكاري وذكرياتي، بعد نصرة الذكرى سبقتها، دمعة صامتة خرجت من طرف جفني، شقت طريقها إلى وراء أذني، كأسيرة كانت ولم تصدق أنه قد فك أسرها بهذه السهولة والرجولة، فالأسير بجسده يأتيه يوم، لتعطى له مفاتيح أغلاله ويساق لمن يبت بحاله، أما أسير الروح مثلي فيظل مكبلاً إلى أن تشرق نور الحرية القريبة البعيدة، حتى تقاسيم وجهي استغربت قدوم طيف دموعي السابحة والهاربة من شبح السفر، فحسب العادات الشرقية البائسة، فإن الدموع لا تذرف من الرجال، بل صنعت لتذرف من النساء على الرجال..!.
تذكرته عندما كان يبحث بين حبات العنب التي أكلت منها الطيور وأحدثت فجوةً فيها وتمايلت لذبولها، كان يبحث عن تلك الحبات، يلتقطها، يأكلها بنهم، كأن أحداً سوف ينتزعها منه، ويقطف لأحفاده أشجع وأكبر عنقودٍ في القرية، قد فاحت بعض صفاته، كما تفوح رائحة النعجة المختنقة، أن البخل من خصاله، يحرس الكرم من شدة حرصه، لكن ما أذكره أنه لم يبع في يومٍ حبة عنب لأحد، بل كان كثير السخاء مع الكل بغير حدود.
أشعلت فيني لهيباً تلك الحادثةُ التي جرت، عندما أقبل على كَرمة هشمت وتناثرت عناقيد العنب على طول الطريق وعرضها، ينظر لها بحزنٍ مع عقدة التبرم في خارطة وجهه، ويقول:
ـ هل في يومٍ من الأيام قد طلب مني أحدهم ما اشتهت نفسه أن تقطف وتأكل، يأخذ منها ما يطيب له ومنعت عنه؟، إن كرم العنب يكفي القرية والقرى الباقية ويفيض، لكن ما يحز في نفسي السرقة في الجهر، لينالوا ما يبتغون دون نزف قطرة عرق، أدركت بعدئذ أن جدي سريالي، فيلسوف من المدرسة الفطرية، يبحث عن اليقين في أصغر الأشياء، يريد أن يعبر بآرائه بقدر ما استطاع، لو عاش لعلم أنه أخطأ عندما ظن أننا سنبقى على تلك البركة، ليتنا بقينا، وويحنا إن لم نعد، ونبقَ.
رحمه الله كان يملك ما فقدناه نحن القناعة، العطاء في محله ومكانه، بساطته قد غلبت عليه، لم يكن يدري أننا نعيش وسط أناسٍ حسب المقولة مثل الديكة التي تعتقد بأن الشمس لا تشرق إلا لتسمع صياحها، ونحن من أصابتنا الرجفة من صياح الديكة، بعدما كنا نصطاد الذئاب بأيدينا ونقتلع رأس الأفعى بأسناننا.
تحول الصياح مابين ليلة وضحاها إلى تنينٍ يملأ بهيجانه أرجاء المعمورة، لأننا صنعناه وألبسناه ذاك الثوب، صرنا نسجد له كالأساطير اليابانية، مؤمنين كل الإيمان بقوته التي اكتسبها من خوفنا وجبننا، بأنه يخرج النار من فمه ليحرق قرانا وأرضنا، التي أصلاً لم يبق فيها شيء يحزن على زوالها، تكلم وثرثر عن الرب، ولا تقرب من خيال التنين.
لم نعد نجابه ولا نقوى إلا على أنفسنا، تناثرت بركة جدي أمام رياح الشح، صار لا همّ لنا إلا أن نصعد على أكتاف بعضنا بعضاً، نوشي بهذا وذاك، حسدٌ قاتل حديث الولادة بيننا، وفساد استفحل، صار يرقد على وسائدنا بعدما كنا نسمع بالماضي عن رجال الدولة، لم يكونوا ليجرؤوا أن يلامس لسان أبنائهم طعاماً وشراباً قد ابتاعوه بمالٍ متسخ، مد اليد صارت عادة، اشتهرنا بها من دمشق حتى قرطبة، يضرب بضمائرنا عرض الحائط، لنبيع شبابنا وكياننا من أجل حفنة من دراهم لا تدوم، بل تديم الفجوة بيننا، تطفئ الدمع الذي كان ينهمر من داخلنا على ماضي الأجداد الذي ليس جديراً بنا، لا يدركون البعد الذي ترسمه أيدٍ خفية ليتغاضوا عن بلع الفتات، ليغدو الشعب كله مخطئاً، ولكي لا يتعالى أحدهم ويطلب الصلاح، حتى يغرسوا في عينيه ما بلع من فتات يوماً وتطبق كل قوانين الأرض على رأسه!.
التنين يتفرج، يضحك علينا، يعتبرنا قد خنا القريب منا ولن يستطيع أن يثق بنا، مثل الخائن الذي قال عنه "نابليون بونابرت": (سرق المال من أبيه ليعطيه بيده للسارق، فلا السارق يشكره، ولا الأب يغفر له عما اقترفت يداه!).
من فعل أيدينا صنعنا الهمّ، وابتلعنا العلقم كسيف وصل إلى أسفل ظهرنا، والهم لم يتجرع منا، حكمنا على أنفسنا بأن نكون بمعزلٍ عن الناجحين، أقنعنا أنفسنا بأن أناملنا لا تصلح إلا لقطاف الزيتون وحمل لفافة التبغ أو لسرقة الفتات، وأن الأنامل التي رسمت لوحة عباد الشمس، نحتت تمثال موسى، ووضعت أحجار سور الصين، ودرست الطب والكيمياء هي أنامل أناسٍ من عالم آخر، والعقول التي وضعت وصنعت الثورات وحركات التحرر والانفتاح هي عقول مستوردة، سجنا أنفسنا في سجن التحسر دون سجان، وأن الأوان قد فاتنا وابتلعنا المفتاح لكي لا نرى نور الشمس الساطعة التي تصب العرق على جباه الأحرار.
شلت أيدينا، صارت هشة، كالبركة الصادقة التي كانت تجمعنا، صارت عاجزة عن حفر كوةٍ صغيرة لينبثق منها شعاع نور ضئيل على مسرح حياتنا، وخرجنا من ديارنا بكلماتنا، ليس من باب مفتوح أمامنا إلا الهروب، والهجرة هو الحل الذي سيجنبنا لهيب التنين الزائف، وأن التراب الذي نعيش عليه لا ينبت فيه الأبطال.
كنتُ مخطئاً في بداية شبابي، بأن الطاقة التي في داخلي قادرة بأن تهدّ جداراً وتثني كومة من الحديد، معتقداً أني سأعمل دون يأس لأخدم وطني الذي حناني له يغطي كل بقاع الأرض، ولن تلهيني لقمة العيش عن أهدافي السامية، لكن حدث عكس ما أريد، فابتعدت كل البعد عن كل ما يصادف طريقي، لأني ما سأفعله ليس إلا صلوات وثنية لا تلقى عند الإله أي حسناتٍ، ليذكرني بأني كردي، مسلوب من أدنى حقوقي سببها حرقة كانت تلدغ كبدي من أحوال الكرد، تناثرهم مثل غبار الطلع في الهواء، حدث ما يسمى بالفلسفة ردة الفعل العكسية، ونمت بذرة الأجداد فيَّ، سقتها ماء أفعالهم وكلامهم، لا يهمني الشعار الثلاثي، فأنا أريد أن أشعر بحريتي من ذاتي، وعالم القمع لطالما ستسعى البشرية لاقتلاعه لأنها الطبيعة الإنسانية.
لكنها طامة كبرى، إن شعرت أن المعظم صار يستنكر وجودك، لتصبح محارباً دون أن تشعر حتى من أقرب الناس منك، ليقحموا برأسك أن الهجرة مكتوبة على جبينك من أول يوم وطئت بها هذه الدنيا لتصبح غريباً في الغربة وغريباً في وطنك وحتى في قبرك ومماتك.
***
شعور زائف تملكته عندما كنت أرى "خضر" قادماً إلى المدرسة بسيارة مرفهة بارحة يقودها سائقه الخا ، الدم يجري بين عينيه، كرشه المستدير، كأن ازدحام المخابز كان ولا زال بسبب التهامه كل رغيفٍ بطريقه، سوارٌ من الذهب الثقيل يزين معصمه ليعبر بكل الطرق أن التخمة أصابته في كل شيء، الأحلام لا مكان لها بين جدران حياتهم لأنها سهلة المنال في أصعب الأشياء، وما معناها إن كانت تتحقق بلا تفاصيل باهظة مثل التي ندفعها ولا نبلغ عتبة بابها..
كنت أساوم نفسي بأني أعلوه بتفكيري ونظرتي المتفائلة لمستقبلي، أحمل أحلاماً سأستلذ بكفاحي لتحقيقها، أنظر إليه بشفقة، تبين أنه كان شعوراً متبادلاً وطريقه الأقصر والأنفع، هو في رأي المجتمع الهش وفي رأي أبي الأذكى والأفضل، يخدعون أنفسهم ويخدعون حتى أحاسيس ألسنتهم.
كان من دون المتفوقين يدب الرعب بكل الرسل، لم أكن أعلم أن هنالك غير الله تهابه الرسل، أصحاب الرسالة وملقنو العلم، لكن كيف درس الهندسة؟ هذا ليس بالسر، يعرفه الجميع بظنهم أنه مكانهم، يفعلون ما يريدون ونحن من ليس له مكان إلا خارج البلاد، أو أن نهتف لهم ونصفق على ما يفعلونه بنا ونرضى، معتقدين أن لا زوال لنعمتهم كما آمن "ستالين" وظن ذلك "هتلر" والعدالة الإلهية لن تصل لباب بيتهم ما دام أنهم يقتلعون كل رأسٍ يخالف آراءهم، لا يفكرون لثوانٍ عندما نقمع الناس، لنضع أنفسنا دقائق وننظر للحياة بعدسة أعينهم التي يرون بها العالم من حولهم لنرى ما سيكون موقفنا وشعورنا من أنفسنا.
القانون والدستور المقدس مخلوق لنا وليس لهم، المخطئ يجب أن يحاسب، لاشيء فوق القانون إلا هم، يحاك كالثوب على حجم أردافهم، متناسين جميع القوانين والأنظمة الوضعية والسماوية التي لا تغتال الآمال.
لن أنسى أستاذي عندما استرقت السمع إليه وهو يجلس مع زميل له، يراقب مسيرة إلزامية حاشدة خرجت تؤيد وتهتف، ظناً أن المدرسة قد خلت وأخذ مجده بكلامه لتلك العبارات:
اهتفوا. واهتفوا باسمه ومجده.. واهتفوا، تظاهروا لأن النعيم الذي أنتم فيه سيزول بزوال هتافكم، كسرة الخبز والخوف من الجوع هي ثمن بخس لوطنكم، تناسيتم حكمة الله أنه لم يخلق فماً إلا وأطعمه ولم يترك ظالماً إلا وقهره ولا مظلوماً إلا ونصره، ولما علم أني أسترق السمع، سكت وابتسم ولا زال إلى يومنا هذا عندما أراه صدفةً، يبتسم في وجهي وأبتسم له، لا يعرف سر تلك البسمة سوانا، أنه كان يعلم الخطيئة كالملايين غيره، لكنه حرم مثلي أن ينادي بها جهراً.
يقول غاندي: (لايستطيعون أن ينتزعوا منا احترامنا لأنفسنا ما لم نتنازل لهم عنه، إن موافقتنا على ما يحدث لنا وسماحنا به هو الذي يؤذينا أكثر بكثير مما يحدث لنا).







 من طرف zahreddin khello الأحد نوفمبر 13, 2016 3:40 am
من طرف zahreddin khello الأحد نوفمبر 13, 2016 3:40 am من طرف zahreddin khello السبت سبتمبر 05, 2015 5:36 pm
من طرف zahreddin khello السبت سبتمبر 05, 2015 5:36 pm من طرف shiar الإثنين مارس 23, 2015 5:18 am
من طرف shiar الإثنين مارس 23, 2015 5:18 am من طرف jegar السبت أكتوبر 25, 2014 9:40 am
من طرف jegar السبت أكتوبر 25, 2014 9:40 am من طرف jegar الأربعاء أكتوبر 15, 2014 3:32 am
من طرف jegar الأربعاء أكتوبر 15, 2014 3:32 am